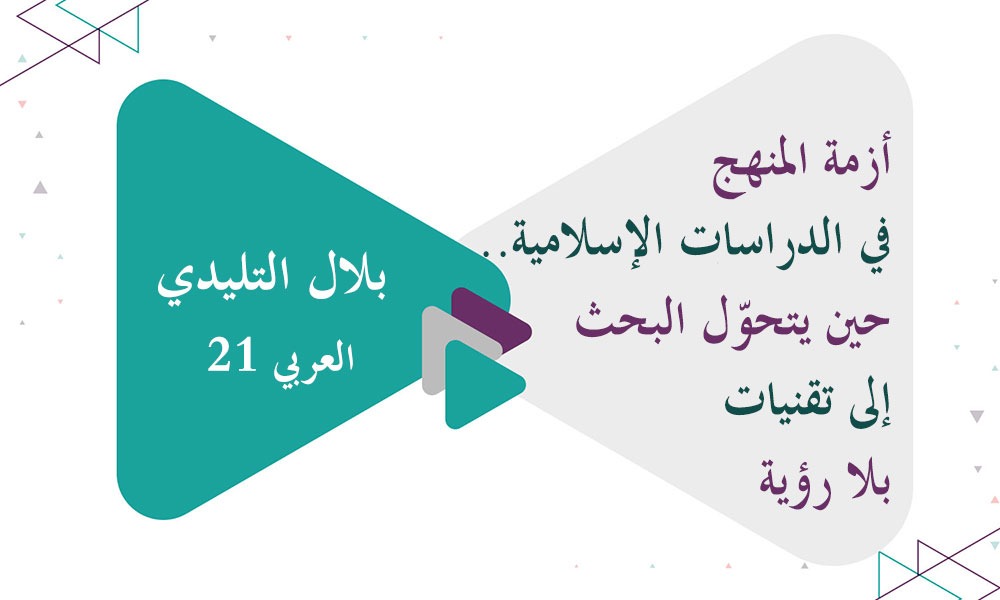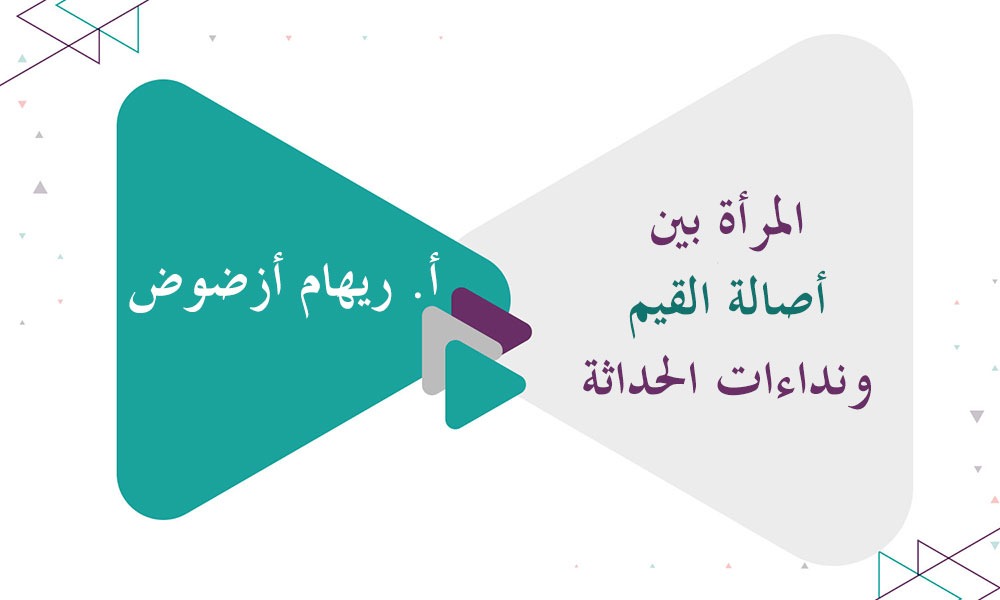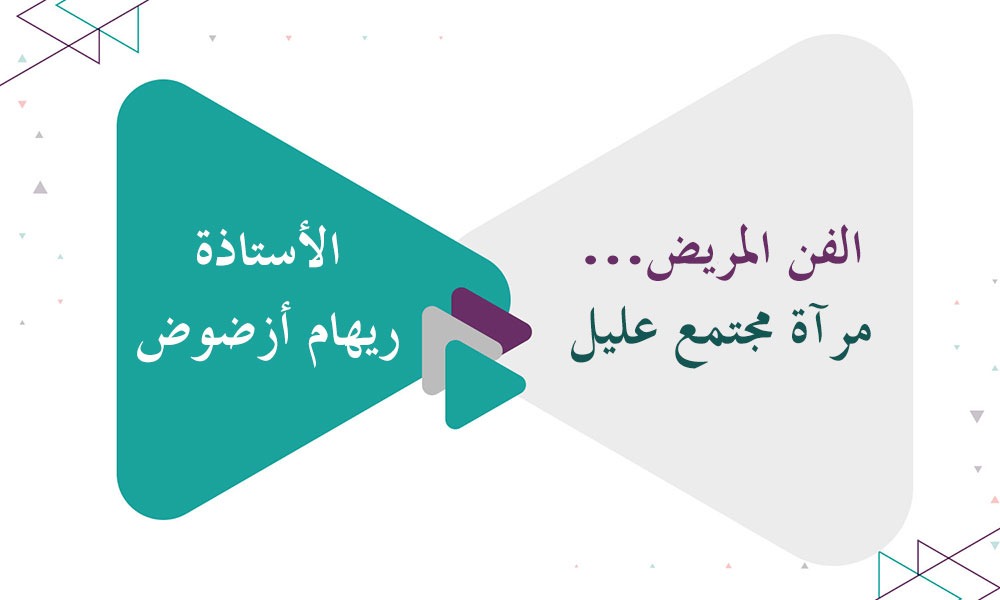يتصدر سؤالُ الدور الحقيقي للمواطن المثقف اليوم ساحةَ النقاش في البيئات التي تبحث عن تأسيس دولة راشدة ومجتمع متماسك، خصوصًا في البلدان التي عاشت حروبًا مدمِّرة وأزمات عميقة. فالمواطن المثقف يتجاوز حضورُه حدودَ التعبير عن الرأي أو النقد العابر، إذ يمتلك قابلية المشاركة في نشوء الدولة وتطورها، ويسهم في توجيه طاقات المجتمع نحو البناء والتنمية وترميم النسيج الاجتماعي.
من أجل ممارسة هذا الدور على أسس سننية واعية، يمكن النظر إلى ثلاثة عوالم كبرى تشكّل مجال عمل المواطن المثقف:
عالم الأفكار، عالم العلاقات البينية، عالم المشاريع والمبادرات على الأرض.
أولًا: عالم الأفكار
عالم الأفكار هو المخزون الحيّ من التصورات والرموز والقيم السائدة بين الناس. في البلدان الخارجة من الحروب تتكوّن في العادة انطباعات أولية حول وجود نقص في الأفكار الراشدة المنتشرة، أو حول حضور أفكار مضطربة تسمّم المجال العام وتغذّي الانقسام. مثل هذه الانطباعات تحتاج إلى بحث ميداني منظم يعتمد على منهجية واضحة: دراسة محتوى الخطاب في المنصات الرقمية، إجراء استطلاعات رأي على الأرض، إجراء مقابلات مع خطباء المساجد وأئمتها، وفحص منهجي لفحوى الخطب الدينية والبرامج الإعلامية والحوارات اليومية. جمع هذه المادة وتحليلها يمنحنا أرضية صلبة لأي خطاب جديد يوجَّه إلى المجتمع، ويجعل الحديث عن «خطاب جديد» امتدادًا لمعرفة دقيقة بالخطاب السائد ودرجات رشده وخلله، لا انطباعًا عامًا أو رغبة إنشائية.
ثانيًا: عالم العلاقات البينية
العالم الثاني هو عالم العلاقات بين مكوّنات الأمة داخل الوطن الواحد. ما يقوله الناس عن بعضهم بعضًا، وما يمارسونه تجاه شركائهم في الوطن، يشكّل في النهاية شبكة علاقات إمّا تعضد أوصال الوطن وتشدّ عراه، أو تدفعه نحو دورة جديدة من التفكك. قراءة هذا العالم تحتاج إلى جهد علمي يرصد أنماط التعايش والتوتر، ويتأمل الذاكرة التاريخية المشتركة، والإشكالات المتراكمة بين المكوّنات، بل حتى بين تيارات الانتماء الواحد داخل المكوّن نفسه؛ فالعلاقات داخل الشريحة الدينية أو المذهبية الواحدة قد تحمل تشققات تماثل أو تفوق التشققات بين المذاهب والطوائف الأخرى. فهم هذه الشبكة يساعد في تصميم خطاب ومبادرات ترمّم النسيج الوطني، وتعالج مواضع الحساسية، وتفتح أبواب الثقة التدريجية بين الفئات المختلفة.
ثالثًا: عالم المشاريع والمبادرات على الأرض
العالم الثالث هو عالم المشاريع والمبادرات التي يتحرك بها المجتمع في الميدان: مبادرات الإعمار، تأسيس المدارس، المشاريع العمرانية، شبكات المواصلات والاتصالات، والهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المرخَّصة. الصورة الدقيقة لهذا العالم تتطلب جهدًا يرسم خريطة للميدان: من يشتغل بماذا؟ في أي منطقة؟ ما حجم الأثر؟ ما المجالات التي تغطيها المبادرات؟ وأيُّ دوائر ما تزال فراغًا تحتاج إلى دخول فاعلين جدد؟ خريطة كهذه تساعد المخططين وقادة المجتمع على توجيه الجهود حيث تتجمع الحاجات الكبرى بدل تكرار المشاريع في المساحات نفسها.
وحين تتكامل هذه الخرائط الثلاث: خريطة عالم الأفكار، وخريطة عالم العلاقات، وخريطة عالم المشاريع، يصبح التخطيط للمستقبل وتوجيه الشباب أكثر يسرا؛ إذ تظهر المساحات الفارغة التي تحتاج إلى مبادرات، وتتضح المساحات المشبعة التي تحتاج إلى تطوير في النوع مع ضبط في العدد. في المقابل، يغدو التوجيه العام في ظل غياب هذه الخرائط أقرب إلى شعارات فضفاضة، تتكرر في الخطب والبيانات من غير التحام حقيقي بمواقع الألم والأمل داخل المجتمع.
من هذه الزاوية يبرز سؤال مهم: أي طريق يخدم البلدان الهشّة في هذه اللحظة التاريخية؟ هل الأفضل الانشغال بتأسيس أحزاب سياسية جديدة، أم بناء مشروع اجتماعي من نوع آخر؟ التجربة في البيئات الضعيفة مؤسسيًّا تشير إلى أنّ الأحزاب التي تنشأ في ظل دولة مترنّحة تصبح عرضة سريعة لتأثير التمويل الخارجي؛ فيتسلل المموّل إلى قرارها الداخلي، ويتحوّل الحزب إلى أداة تجاذب بين قوى خارج الحدود، بدل تحوله إلى أداة تجميع وتوحيد داخل الوطن.
لهذا تبدو الحاجة متجهة في هذه المرحلة نحو ما يمكن تسميته «المبادرات المجتمعية الواسعة». الفكرة هنا أن يختار المجتمع مدينة أو مدينتين، قرية أو قريتين، وتُوضع لهما خطة باعتبارهما نموذجًا حيًا: فرق متعدّدة تعمل في التعليم، والصحة، والعمران، والاقتصاد المحلي، بهدف إحياء المنطقة بكاملها وتحويلها إلى مجال يعبّر عن قدرة المجتمع على تنظيم نفسه وابتكار حلوله ضمن فضاء القانون.
تقدّم تجربة قرية تفاهنة الأشراف في مصر مثالًا ملهمًا على هذا النمط من المبادرات. قرية صغيرة يقارب عدد سكانها ألفي ساكن، بدأت القصة فيها بمشروع بسيط لتربية الدواجن أطلقه بعض الأهالي. توسعت المزارع تدريجيًا، وارتفع الدخل، ثم وُجِّه جزء معتبر من العوائد إلى إعمار القرية نفسها: إنشاء مدارس، تعبيد طرقات، تحسين شبكات الصرف الصحي، حتى الوصول إلى إنشاء خط سكة حديد يخدم المنطقة. عبر الزمن تحوّلت القرية إلى مركز يستقبل أبناء القرى المجاورة للتسوق والتعلم، وتحولت من قرية فقيرة معزولة إلى نموذج لقرية مكتفية بأبنائها المتعلمين وبيئتها النظيفة واقتصادها المحلي الحيّ.
وفي وجدة بالمغرب برزت تجربة أخرى لإحياء مدينة قديمة أثرية عانت من الهجران. مبادرة مجتمعية جمعت أهل المدينة حول مشروع لترميم الآثار، وإعادة تشكيل الشارع العام، وإنشاء مركز ثقافي، مع التفاهم مع الدولة لمدّ فرع من الطريق السريع نحو المنطقة، وتحويل جزء منها إلى منطقة صناعية تؤجَّر للشركات. حركة الإحياء هذه وفّرت فرص عمل لأبناء المنطقة في موطنهم، وأعادت الروح إلى مدينة كانت تتجه نحو الانطفاء العمراني والإنساني.
هذا النمط من المبادرات يجسّد الحلم الذي تحدّث عنه مالك بن نبي: شارع يتولّى سكانه نظافته، مسجد يعتني به جيرانه، مدرسة يحرسها وعي أولياء الأمور، بيت يرتّبه أهله، ومجتمع ينهض بذاته ويقود حركة حياته اليومية من موقع الشراكة والمسؤولية، لا من موقع الانتظار لما يأتي من «فوق» فقط. عند هذه الدرجة يتحول المجتمع المدني إلى شريك حقيقي للدولة في حمل أعباء العمران.
في قلب هذه الصورة يقف المواطن المثقف بوصفه عنصرًا محوريًّا. هذا المواطن يشارك في إعداد خرائط الأفكار والعلاقات والمشاريع، ويسهم في الدراسات الميدانية التي تكشف طبيعة الخطاب السائد، ويرصد مبادرات الإحياء الناجحة، ويعرّف الشباب بالنماذج الملهمة، ويوجه الطاقات نحو مساحات الفراغ داخل الخرائط الثلاث. في البلدان التي عاشت الحروب، يتحول هذا الجهد التوعوي إلى إعداد جيل يمتلك وعيًا خرائطيًا ببلده: أين تقف الأفكار؟ كيف يتشكّل النسيج الاجتماعي؟ أين تعمل المبادرات؟ وأيُّ مناطق تنتظر من يحييها؟
حين تتكوّن هذه الرؤية الجماعية يصبح المجتمع المدني أكثر قدرة على إطلاق مبادرات واسعة تعيد بناء المدن والقرى المتعبة، وتمنح الدولة قاعدة اجتماعية حية تستند إليها، في دائرة تكامل بين دولة تبحث عن الاستقرار ومجتمع يملك إرادة النهوض واستعداد المشاركة في حمل مشروع العمران.
عالم الأفكار، عالم العلاقات البينية، عالم المشاريع والمبادرات على الأرض.
أولًا: عالم الأفكار
عالم الأفكار هو المخزون الحيّ من التصورات والرموز والقيم السائدة بين الناس. في البلدان الخارجة من الحروب تتكوّن في العادة انطباعات أولية حول وجود نقص في الأفكار الراشدة المنتشرة، أو حول حضور أفكار مضطربة تسمّم المجال العام وتغذّي الانقسام. مثل هذه الانطباعات تحتاج إلى بحث ميداني منظم يعتمد على منهجية واضحة: دراسة محتوى الخطاب في المنصات الرقمية، إجراء استطلاعات رأي على الأرض، إجراء مقابلات مع خطباء المساجد وأئمتها، وفحص منهجي لفحوى الخطب الدينية والبرامج الإعلامية والحوارات اليومية. جمع هذه المادة وتحليلها يمنحنا أرضية صلبة لأي خطاب جديد يوجَّه إلى المجتمع، ويجعل الحديث عن «خطاب جديد» امتدادًا لمعرفة دقيقة بالخطاب السائد ودرجات رشده وخلله، لا انطباعًا عامًا أو رغبة إنشائية.
ثانيًا: عالم العلاقات البينية
العالم الثاني هو عالم العلاقات بين مكوّنات الأمة داخل الوطن الواحد. ما يقوله الناس عن بعضهم بعضًا، وما يمارسونه تجاه شركائهم في الوطن، يشكّل في النهاية شبكة علاقات إمّا تعضد أوصال الوطن وتشدّ عراه، أو تدفعه نحو دورة جديدة من التفكك. قراءة هذا العالم تحتاج إلى جهد علمي يرصد أنماط التعايش والتوتر، ويتأمل الذاكرة التاريخية المشتركة، والإشكالات المتراكمة بين المكوّنات، بل حتى بين تيارات الانتماء الواحد داخل المكوّن نفسه؛ فالعلاقات داخل الشريحة الدينية أو المذهبية الواحدة قد تحمل تشققات تماثل أو تفوق التشققات بين المذاهب والطوائف الأخرى. فهم هذه الشبكة يساعد في تصميم خطاب ومبادرات ترمّم النسيج الوطني، وتعالج مواضع الحساسية، وتفتح أبواب الثقة التدريجية بين الفئات المختلفة.
ثالثًا: عالم المشاريع والمبادرات على الأرض
العالم الثالث هو عالم المشاريع والمبادرات التي يتحرك بها المجتمع في الميدان: مبادرات الإعمار، تأسيس المدارس، المشاريع العمرانية، شبكات المواصلات والاتصالات، والهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المرخَّصة. الصورة الدقيقة لهذا العالم تتطلب جهدًا يرسم خريطة للميدان: من يشتغل بماذا؟ في أي منطقة؟ ما حجم الأثر؟ ما المجالات التي تغطيها المبادرات؟ وأيُّ دوائر ما تزال فراغًا تحتاج إلى دخول فاعلين جدد؟ خريطة كهذه تساعد المخططين وقادة المجتمع على توجيه الجهود حيث تتجمع الحاجات الكبرى بدل تكرار المشاريع في المساحات نفسها.
وحين تتكامل هذه الخرائط الثلاث: خريطة عالم الأفكار، وخريطة عالم العلاقات، وخريطة عالم المشاريع، يصبح التخطيط للمستقبل وتوجيه الشباب أكثر يسرا؛ إذ تظهر المساحات الفارغة التي تحتاج إلى مبادرات، وتتضح المساحات المشبعة التي تحتاج إلى تطوير في النوع مع ضبط في العدد. في المقابل، يغدو التوجيه العام في ظل غياب هذه الخرائط أقرب إلى شعارات فضفاضة، تتكرر في الخطب والبيانات من غير التحام حقيقي بمواقع الألم والأمل داخل المجتمع.
من هذه الزاوية يبرز سؤال مهم: أي طريق يخدم البلدان الهشّة في هذه اللحظة التاريخية؟ هل الأفضل الانشغال بتأسيس أحزاب سياسية جديدة، أم بناء مشروع اجتماعي من نوع آخر؟ التجربة في البيئات الضعيفة مؤسسيًّا تشير إلى أنّ الأحزاب التي تنشأ في ظل دولة مترنّحة تصبح عرضة سريعة لتأثير التمويل الخارجي؛ فيتسلل المموّل إلى قرارها الداخلي، ويتحوّل الحزب إلى أداة تجاذب بين قوى خارج الحدود، بدل تحوله إلى أداة تجميع وتوحيد داخل الوطن.
لهذا تبدو الحاجة متجهة في هذه المرحلة نحو ما يمكن تسميته «المبادرات المجتمعية الواسعة». الفكرة هنا أن يختار المجتمع مدينة أو مدينتين، قرية أو قريتين، وتُوضع لهما خطة باعتبارهما نموذجًا حيًا: فرق متعدّدة تعمل في التعليم، والصحة، والعمران، والاقتصاد المحلي، بهدف إحياء المنطقة بكاملها وتحويلها إلى مجال يعبّر عن قدرة المجتمع على تنظيم نفسه وابتكار حلوله ضمن فضاء القانون.
تقدّم تجربة قرية تفاهنة الأشراف في مصر مثالًا ملهمًا على هذا النمط من المبادرات. قرية صغيرة يقارب عدد سكانها ألفي ساكن، بدأت القصة فيها بمشروع بسيط لتربية الدواجن أطلقه بعض الأهالي. توسعت المزارع تدريجيًا، وارتفع الدخل، ثم وُجِّه جزء معتبر من العوائد إلى إعمار القرية نفسها: إنشاء مدارس، تعبيد طرقات، تحسين شبكات الصرف الصحي، حتى الوصول إلى إنشاء خط سكة حديد يخدم المنطقة. عبر الزمن تحوّلت القرية إلى مركز يستقبل أبناء القرى المجاورة للتسوق والتعلم، وتحولت من قرية فقيرة معزولة إلى نموذج لقرية مكتفية بأبنائها المتعلمين وبيئتها النظيفة واقتصادها المحلي الحيّ.
وفي وجدة بالمغرب برزت تجربة أخرى لإحياء مدينة قديمة أثرية عانت من الهجران. مبادرة مجتمعية جمعت أهل المدينة حول مشروع لترميم الآثار، وإعادة تشكيل الشارع العام، وإنشاء مركز ثقافي، مع التفاهم مع الدولة لمدّ فرع من الطريق السريع نحو المنطقة، وتحويل جزء منها إلى منطقة صناعية تؤجَّر للشركات. حركة الإحياء هذه وفّرت فرص عمل لأبناء المنطقة في موطنهم، وأعادت الروح إلى مدينة كانت تتجه نحو الانطفاء العمراني والإنساني.
هذا النمط من المبادرات يجسّد الحلم الذي تحدّث عنه مالك بن نبي: شارع يتولّى سكانه نظافته، مسجد يعتني به جيرانه، مدرسة يحرسها وعي أولياء الأمور، بيت يرتّبه أهله، ومجتمع ينهض بذاته ويقود حركة حياته اليومية من موقع الشراكة والمسؤولية، لا من موقع الانتظار لما يأتي من «فوق» فقط. عند هذه الدرجة يتحول المجتمع المدني إلى شريك حقيقي للدولة في حمل أعباء العمران.
في قلب هذه الصورة يقف المواطن المثقف بوصفه عنصرًا محوريًّا. هذا المواطن يشارك في إعداد خرائط الأفكار والعلاقات والمشاريع، ويسهم في الدراسات الميدانية التي تكشف طبيعة الخطاب السائد، ويرصد مبادرات الإحياء الناجحة، ويعرّف الشباب بالنماذج الملهمة، ويوجه الطاقات نحو مساحات الفراغ داخل الخرائط الثلاث. في البلدان التي عاشت الحروب، يتحول هذا الجهد التوعوي إلى إعداد جيل يمتلك وعيًا خرائطيًا ببلده: أين تقف الأفكار؟ كيف يتشكّل النسيج الاجتماعي؟ أين تعمل المبادرات؟ وأيُّ مناطق تنتظر من يحييها؟
حين تتكوّن هذه الرؤية الجماعية يصبح المجتمع المدني أكثر قدرة على إطلاق مبادرات واسعة تعيد بناء المدن والقرى المتعبة، وتمنح الدولة قاعدة اجتماعية حية تستند إليها، في دائرة تكامل بين دولة تبحث عن الاستقرار ومجتمع يملك إرادة النهوض واستعداد المشاركة في حمل مشروع العمران.