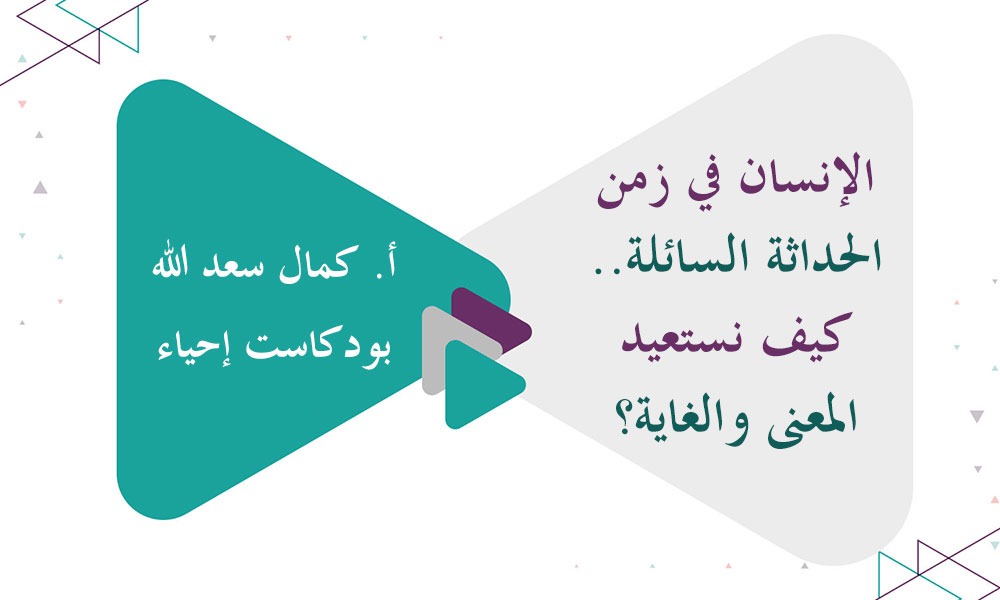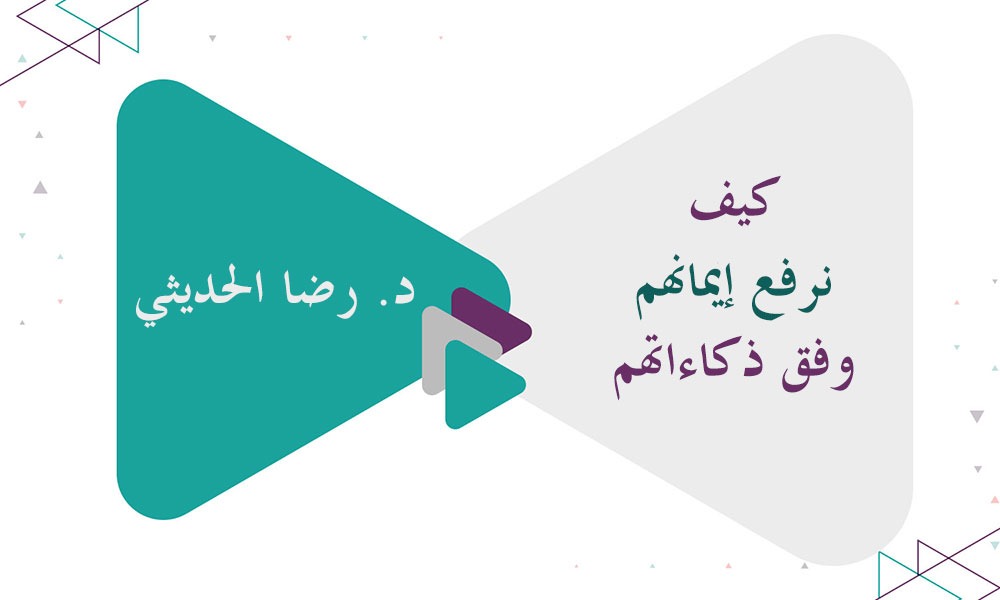أولًا: تجربة المعرض التسويقي والبركة
فاقترحت على الزملاء أن نستأجر القاعة، ونفعل مثل المعرض التسويقي للشركة. وبالفعل كان ذلك يوم سبت، أذكر ذاك اليوم. استأجرنا المكان، وكانت عندنا لوحات معيّنة وضعناها في القاعة.
المحاسب الذي كان عندي في الشركة تحفّظ على المبلغ، قال: سندفع الأجرة، وربما لا يأتي أحد وتكون علينا خسارة. قلت له: يا أخي، التسويق لا بد له من إنفاق؛ البوسترات موجودة، واللوحات موجودة، وإن شاء الله يأتي من يأتي.
وبالفعل أخذنا المعرض، ووضعنا اللوحات وبعض الكتيبات التعريفية، وانتظرنا. لم يأتِ إلا اثنان أو ثلاثة، ثم اضطررت في الساعة الأخيرة من البرنامج أن أصعد إلى فصل فيه بعض الأخوات الماليزيات يدرسن عندنا، وعددهن ستّ. قلت: على الأقل أدعوهن زيارة للمعرض.
دخلت الصف، وقلت لهن: السلام عليكم، نحن عندنا معرض في الدور السادس، فبعد الدرس تفضّلن عندنا للزيارة. قلن: إن شاء الله. ثم ذهبت، ولم تأتِ من الست إلا واحدة. تقريبًا من الصباح إلى وقت الظهر عدد الحضور كان بسيطًا.
ثم جاءت هذه السيدة، وكانت كبيرة في السن، فمرّت على منتجاتنا وعلى برامجنا وكذا وكذا، وسألتني عن برنامج معيّن نقدّمه في الروبوتكس مع اللغة الإنجليزية. قلت لها: نحن نقدّم هذا البرنامج. قالت: أنا معي مجموعة من الطلاب، أريد هذا البرنامج أن يُنفَّذ مع هذه المجموعة، وأنا أتكفّل بالقيمة بالكامل إن شاء الله، مجموعة من الطلاب اللاجئين.
قلت لها: ممتاز جدًّا. سألَت عن عدد الطلاب، فقلنا: كذا وكذا، وسنفعل لكم (الباكيج) المناسب. سألت عن المدّة، قلت: سنة، دورة فيها تفاصيل كثيرة.
هذا كان يوم السبت. رجعتُ إلى البيت، ويوم الأحد اشتغلت على عرض السعر، فطلع مبلغًا كبيرًا حقيقة. قلت: هذا المبلغ يكفي لهؤلاء، أن تُغطَّى هذه المجموعات وتُدفَع هذه الرسوم الدراسية. كان المبلغ أكثر من 107000، رسوم دراسية كاملة، كأنها مدرسة.
قلت: على أي حال، أنا سأرسل هذا ما عندي، هذا هو العرض. فأرسلته. فقالت: جيد، إذا أنت قلت نعم، خلاص، إن شاء الله غدًا آتي إليكم وأدفع المبلغ.
جاءت في اليوم الثالث، ودفعت المبلغ (كاش)، وكنت ما زال في نفسي شيء؛ قلت: إن لم ينزل هذا المبلغ في الحساب، فهذه القصة تبقى غريبة. وبالفعل يوم الثلاثاء أودعنا الشيك في البنك، ويوم الخميس نزل المبلغ بالتفاصيل.
الشاهد يا إخوة: البركة. هذا العدد القليل، ومع ذلك هذا الأثر الكبير. أنتم دعوتم ونشرتم… هذه هي البركة، هذا مفهوم البركة؛ ربما يأتي عدد كبير، جمع غفير من الناس لحضور فعالية معيّنة، ثم لا يكون هناك أثر أو نتائج. وربما يأتي عدد بسيط، ويكون هناك أثر كبير.
من ذاك الموقف صارت عندي قناعة ألا ألتفت إلى العدد، وإنما إلى الكيف: ماذا سيقدَّم؟ وماذا يمكن أن ينتج هذا اللقاء؟
ثانيًا: تجربة اكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي
خطر في بالي خاطر؛ كنت أتابع مع البروف أكرم – جزاه الله خيرًا – وكان مهتمًّا جدًّا بالنشر والدعوة، وأعطاني بعض الأرقام.
بدأت أعمل تجربة: كيف أكتشف أن هذا العمل مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ أخذت مجموعة من المقاطع من أعمال معيّنة: من بحث، من كتاب… ثم استخدمت خمسة مواقع مختلفة لاكتشاف الأعمال المكتوبة بالذكاء الاصطناعي. بعض هذه المواقع مدفوع 100%، وهذه لا أستطيع دخولها؛ لأنها غالية، فأخذت المواقع الأشهر في اكتشاف الأعمال المصنوعة بالذكاء الاصطناعي.
وجدت اختلافًا كبيرًا بينها: تأخذ مقطعًا من كتاب، تضعه في موقع فيقول: 100% كتابة إنسان، وتضعه في موقع ثانٍ فيقول: 70% ذكاء اصطناعي، وثالث يقول: 40% ذكاء اصطناعي. صارت عندي ربكة.
قلت: دعني أقوم بالتجربة بنفسي. ماذا فعلت؟ كتبت تعليمات للذكاء الاصطناعي: أريد مقالة من 150 كلمة بهذه التعليمات. فكتبها لي الذكاء الاصطناعي. وبناءً على هذه التعليمات نفسها كتبت أنا مقالة أخرى 100% من فكري.
أخذت القطعتين، وبدأت أدخلهما في مكتشفات الذكاء الاصطناعي؛ نفس المشكلة قائمة: المقالة التي كتبتها أنا من رأسي 100%، موقع يقول: 100% كتابة بشرية، موقع آخر يقول: 90% ذكاء اصطناعي، وثالث يقول: 60%.
ثم أخذت المقالة المكتوبة بالذكاء الاصطناعي 100%، ووضعتها في هذه المواقع؛ أغلبها اكتشف أنها ذكاء اصطناعي، لكن موقعًا واحدًا فقط قال: مختلطة.
كيف أكتب من رأسي 100%، ويقول الذكاء الاصطناعي: هذا مكتوب 100% ذكاء اصطناعي؟ إذًا هنا مشكلة، وليس في موقع واحد؛ استخدمت خمسة محرّكات مختلفة، وكلها تعطي نتائج متضاربة.
ثالثًا: حوار مع الذكاء الاصطناعي حول آلية الاكتشاف
قلت: دعني أتحدث مع الذكاء الاصطناعي نفسه. دخلت على أشهر موقعين: ديب سيك (DeepSeek) وتشات جي بي تي (ChatGPT)، وطرحت المشكلة كاملة.
اتضح أن محرّكات اكتشاف الذكاء الاصطناعي تعتمد غالبًا على نمط الكتابة؛ فإذا كان النمط متشابهًا، خاليًا من الأخطاء، متزنًا 100%، تعتبره ذكاءً اصطناعيًّا.
مثلًا: عندما تكتب جملًا مباشرة، واحدة وراء الأخرى، دون تفاصيل أو تفرّعات، يقول لك: هذه لغة ذكاء اصطناعي، وليست لغة بشر. مع أنّ النص قد يكون من إنسان 100%.
سألت: ماذا نفعل إذًا؟ قال: إن أردت ألا يتعرّف الذكاء الاصطناعي على النص على أنه مكتوب بالذكاء الاصطناعي، فأظهر في الكتابة أنك إنسان.
سألت: كيف؟ أعطاني بعض التعليمات. مثلًا:
-
أن أكتب عبارات شعورية: «وأنا أكره هذا الشيء كرهًا شديدًا»، «أستمتع بهذا الأمر»، ونحو ذلك.
-
أن أضيف إشارات إلى فصول لاحقة: «وسأناقش هذه القضية في الفصل الثاني من كتابي».
أخذت المقالة التي كتبها الذكاء الاصطناعي 100%، وأضفت عليها تعديلات بسيطة جدًّا – من 10 إلى 15% – ثم أعدت فحصها في المحركات. أغلبها قال: هذا عمل إنساني.
أما المقالة التي كتبتها أنا 100% بلغة عربية منضبطة، علامات ترقيم صحيحة، أسلوب متماسك، فقد حكم عليها بعض المحركات بأنها ذكاء اصطناعي.
إذًا هناك مشكلة حقيقية في أدوات الكشف.
رابعًا: أثر ذلك على الجامعات والطلاب
على مستوى الجامعات، طلاب يكتبون أبحاثًا، فيأخذ المشرف البحث ويضعه في البرنامج، فيقول له: هذا ذكاء اصطناعي، فيحرم الطالب من الدرجات، مع أن الطالب كتب بيده.
هذه قضية تحتاج إلى باحثين في اللغة العربية، ومؤسسات جامعية وبحثية متخصصة، تضع معايير عادلة؛ التفريق بين النص البشري والنص الآلي تفريقًا كاملًا ربما صعب، لكن على الأقل نصل إلى نسبة نطمئن لها، حتى لا يُظلَم أحد.
خامسًا: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التدريس
أنا كمعلم عندما أذهب إلى الدرس، سابقًا كنا نحضّر يدويًّا. الآن الذكاء الاصطناعي يغني عن جزء كبير من التحضير؛ قبل أن أذهب إلى الدرس يمكن أن يعطيني محاضرة كاملة أقرأها فقط.
السؤال: لماذا لا أستفيد من الذكاء الاصطناعي، وأبقى عادلًا مع المؤسسة والطالب؟
لا مانع عندي أن أحضّر المادة العلمية التي أنا مسؤول عنها، ثم أعرضها على الذكاء الاصطناعي من أجل طلب التحسينات والتعديلات؛ لأنه يبحث بسرعة هائلة في آلاف الملفات، ثم يعطيني رأيًا: هذا يمكن تحسينه، وهذا يمكن إضافة مثال له، وهكذا.
بهذه الطريقة تصبح المادة العلمية التي سأقدّمها للطلاب أكثر ضبطًا وتربويّة؛ لأن الذكاء الاصطناعي يعطيني ملاحظات دقيقة على نقاط الضعف التي قد أغفل عنها.
منذ أكثر من سنة وأنا أفعل هذا؛ لا أدخل الفصل إلا وقد وضعت مادتي في النظام، وأقول له: أعطني اقتراحاتك. أذكر له: عندي فصل مدته ساعة ونصف، لطلاب بهذا المستوى، في هذه البلد، ثم أطلب رأيه.
يعطيني أفكارًا لطيفة وجميلة ساعدت كثيرًا في تطوير التعليم في الفصل، مثل:
-
كيف أستفز الطلاب بالسؤال.
-
كيف أطرح الأسئلة المفتوحة.
-
كيف أوزّع الأنشطة.
هذه الجوانب يمكن أن نؤلف فيها كتبًا، ونعمل دورات تدريبية: كيف يستفيد المعلّم من الذكاء الاصطناعي قبل أن يذهب إلى الفصل.
سادسًا: تجربة أكاديمية الصفّا في التعليم الرقمي للقرآن الكريم
شاركنا الدكتور سامر تجربته في تأسيس أكاديمية تُعنى بالقرآن الكريم، وهو من الأعضاء المؤسسين.
قال: اسمي سامر سمارة من فلسطين، محاضر في كلية القرآن والسنة في الجامعة الإسلامية (IU…)، منذ 2012 إلى الآن. أدرّس علم الحديث، وبدأت تدريس علم القراءات.
تجربتنا في أكاديمية الصفّا: الأكاديمية مرخّصة في ماليزيا من 2018. بدأنا العمل على الأرض، نستهدف الجالية العربية بشكل خاص؛ لأن الماليزيين عندهم نظامهم الخاص.
حتى جاءت كورونا، وأغلقت كثير من الشركات، فدار السؤال: ماذا نفعل الآن؟ يسر الله أن نطلق أول فوج عندنا أونلاين، وكان هذا أول طريقنا في الرقمنة. لم نتوقع هذا النجاح الكبير، بفضل الله.
ابتدأنا بـ 80 طالبًا وأربعة معلمين. اليوم عندنا 3000 طالب، والعدد مرشّح أن يزيد إلى 4000 بإذن الله تعالى. الإقبال على الحلقات كبير؛ التعليم الرقمي يسهل جدًّا عملية التعليم، خاصة للمهتمين؛ بدل أن يبحث الطالب عن شيخ أو أستاذ، الشيخ أو الأستاذ يصل إليه في الوقت المناسب، والمكان المناسب.
الحلقات تبدأ من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 أو 11 ليلًا.
بدأنا بتحفيظ القرآن الكريم أولًا، ثم التجويد، ثم استهدفنا الحفاظ بالتثبيت، ثم افتتحنا قسم «الكتاتيب» الذي يستهدف الأطفال من سنّ صغيرة إلى 13 سنة. زدنا «الحافظ البارع»، ثم بدأنا في الدبلومات:
-
دبلوم تأهيل الحافظ منذ سنتين.
-
برنامج قراءات مدته ثلاث سنوات – يُفتتح قريبًا إن شاء الله.
-
قسم الاستشارات القرآنية، سيُطلق بإذن الله تعالى.
ما نتميز به – بفضل الله – أمران:
-
التركيز على الجودة؛ منافسون كثيرون موجودون، لكن العناية بالجودة جعلت طلابنا معروفين؛ أينما ذهبوا يسأل الناس: من أين قرأتم؟ فيقولون: من أكاديمية الصفّا.
-
المتابعة الحثيثة؛ التزام الطالب بالقرآن لسنتين أو ثلاث يحتاج إلى نفس طويل؛ عندنا طاقم إداري وأكاديمي يتابع الطلاب والمعلمين متابعة دقيقة؛ الطالب إذا غاب يومًا أو يومين أو ثلاثة يتواصل معه الفريق.
عدد العاملين 164 معلمًا، و18 مشرفًا بين إشراف أكاديمي وإداري، وفريق فني من مبرمجين، ومحاسبين، وموارد مالية. الأمور في تطور وبركة، ونستهدف أسواقًا غير عربية؛ نبحث الآن سوق كندا، وندرس التراخيص.
من فضل الله: بدأنا بعدد قليل – اثنان أو ثلاثة مع 80 طالبًا – والآن 3000 طالب، والطلبات في ازدياد، ورسائل القبول مهولة.
قطاع التعليم الإلكتروني فرصة كبيرة، والواجب أن يستثمر الإنسان في التخصص الذي يبدع فيه، ويحيط نفسه بناس عندهم انتماء وإيمان بالفكرة؛ إذا وُجد هؤلاء، ومع توفيق الله، يكبر المشروع وتعم الفائدة.
القرآن الكريم كلام الله العظيم، ويستحق أن يُخدَم بأفضل ما عندنا؛ لذلك نسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات؛ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى.
سابعًا: مداخلة حول الإدارة والتطوير والجودة
ذُكرت تجربة الشركات؛ مثل شركة «نوكيا» التي سيطرت على السوق، ثم تراجعت بسبب عدم التطوير وعدم مواكبة الأحداث، فجاءت شركات أخرى وأخذت مكانها.
الفكرة: لا بد من التطوير والتحديث، وإدخال برامج جديدة، دون التفريط في الجودة والإتقان.
القضية المركزية: القرآن الكريم يجب أن يُخدم بأفضل ما لدينا؛ لذلك الإدارة والتخطيط الاستراتيجي جزء أساسي من حفظ هذا العمل واستمراره.
ثامنًا: الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة وتقليل المخاطر
تحدث الدكتور أكرم عن الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. أشار إلى أن رحلته مع العلم مستمرة، وأنه يسعى لامتلاك الأدوات اللازمة.
ذكَر أن الرسول ﷺ استخدم الوسائل المتاحة في زمنه: الرسم على الرمل، الحصى، وغيرها. اليوم الأدوات تغيرت، والذكاء الاصطناعي أداة من هذه الأدوات التي سخرها الله لنا.
الذكاء الاصطناعي فرع من علوم الحاسوب، هدفه محاكاة العقل البشري؛ البرامج التقليدية تحتاج تعليمات دقيقة، أما الذكاء الاصطناعي فيتعلم من البيانات.
القفزة الحديثة في 2022 مع ظهور ChatGPT جاءت من عاملين:
-
تجمّع البيانات (الـ Data) النصية بكميات ضخمة.
-
توفر الحواسيب السريعة (GPU) القادرة على تحليل هذه البيانات.
البيانات أصبحت «ذهب العصر».
أشار أيضًا إلى مستقبل البرمجة بالمحادثة؛ المبرمج يقول للنظام: «أريد تطبيقًا للفئة العمرية كذا، في الموضوع الفلاني…» فيصمم له البرنامج دون كتابة أكواد تقليدية.
كما ذكر نماذج أخرى؛ مثل اللواصق الذكية التي تقرأ المشاعر، والأسئلة الأخلاقية حول الكمّ الهائل من البيانات التي تُجمَع عن الإنسان يوميًّا، وتأثير ذلك على المحاسبة الذاتية والخصوصية.
تاسعًا: أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم والدرجات العلمية
لاحظ الدكتور أن طلاب البكالوريوس يستفيدون من الذكاء الاصطناعي في التعلم أكثر من طلاب الدراسات العليا؛ لأن امتحان البكالوريوس غالبًا تحريري داخل القاعة، فيستخدم الطالب الذكاء الاصطناعي لفهم المفاهيم قبل الامتحان.
أما الدراسات العليا التي تعتمد على أطروحة كاملة من أولها إلى آخرها، فهناك إشكالات أكبر؛ بعض الطلاب يعتمدون على الذكاء الاصطناعي اعتمادًا واسعًا، ما يخلق تحديات في التقييم.
لذلك تحوّل بعض الأساتذة إلى:
-
الاعتماد على التقييم الشفهي والعروض التقديمية.
-
طلب الأبحاث مكتوبة باليد، لا بالحاسوب.
-
التركيز على الامتحانات التحريرية غير المفتوحة.
ومع ذلك، الإشكال في التمييز بين النص البشري والآلي ما زال قائمًا، خاصة في الدراسات العليا.
عاشرًا: الفتوى الإلكترونية والذكاء الاصطناعي
أثير موضوع الفتوى الإلكترونية؛ كثير مما يسمّى «فتاوى» على الشبكة في الحقيقة ليس إنشاء فتوى جديدة، بل «استرجاع حكم» موجود في كتب الفقه؛ سؤال عن الصيام، أو الربا، أو أحكام النسيان… كلها أحكام موجودة.
الذكاء الاصطناعي هنا يقوم بعملية ربط بين السؤال والحكم الفقهي المدوّن، أكثر من كونه يُنشئ فتوى جديدة. مع ذلك تبقى الحاجة إلى ضوابط أخلاقية وعلمية لاستخدامه في المجال الشرعي.
حادي عشر: أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي ووثائق الضبط
طُرح اقتراح بإعداد «وثيقة حاكمة» في البيئة العلمية حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته وتطبيقاته، تتناول:
-
ضوابط الاستفادة في البحث العلمي.
-
نسبة المحتوى المسموح بها من الذكاء الاصطناعي في الأبحاث.
-
أمانة الباحث في التصريح بالمصادر.
كما ذُكر أن الذكاء الاصطناعي يعطي أحيانًا إجابات خاطئة إذا كانت البيانات المنحازة كثيرة؛ فإذا كتب ألف شخص في الإنترنت أن 2+2=5، وجرى تدريب نموذج على هذه البيانات، فقد يعطي النتيجة الخاطئة؛ لذلك في المسائل الشرعية والعلمية الدقيقة لا بد من مراجعة المصادر والتحقق.
ثاني عشر: الذكاء الاصطناعي، التحيّز، وفقّاعة المحتوى
أشار الدكتور إلى أن الذكاء الاصطناعي يتأثر بما نطلبه منه باستمرار؛ إذا اعتاد شخص أن يسأل بنمط معين، سيعطيه النظام باستمرار أجوبة قريبة من هذا النمط، فيعيش فيما يسمّى «فقاعة المحتوى».
هذه الفقاعة تجعل الإنسان يظن أن قراراته حرة تمامًا، بينما هي متأثرة بما يعرضه عليه النظام بناء على تاريخه في الأسئلة.
التحديات تشمل:
-
التحيّز.
-
الشفافية.
-
تفسير النتائج.
وكلها تحتاج إلى وعي وبحث مستمر.
ثالث عشر: منصّة «أُريد» ومشاريعها العلمية
قُدّمت نبذة عن منصة «أُريد» العلمية:
-
تأسست في ماليزيا عام 2016 من واقع احتياج النخب العلمية العربية لمنصة عربية تجمعهم في بيئة واحدة.
-
تطورت المنصة حتى بلغ عدد أعضائها 131000 باحث مسجّل.
-
جرى تحويلها إلى مؤسسة وقفية مسجّلة في تركيا تحت اسم «أُريد فاونديشن».
-
من مشروعاتها:
-
منصة «أُريد».
-
جامعة أُريد الدولية للدراسات العليا.
-
مشروع «القرية العلمية» في تركيا – دوزجه.
-
منصة «أبناء العلماء» لليافعين.
-
منصة «Observer» للمخيمات الافتراضية ومصاحبة المتعلم.
-
النصيحة الأساسية: كل واحد من طلاب العلم والباحثين يحمل معه «مشروعًا»؛ فالدكتور سامر مثلًا أسس مشروعًا أثّر في أماكن كثيرة في العالم، وهكذا يمكن للاستفادة من التجربة الماليزية أن تولّد مشروعات مماثلة في بلدان متعددة.
رابع عشر: فقرة التعارف بين الحضور
جرى تعارف بين الحضور، وذُكر عدد من الأسماء والتخصصات باختصار، مثل:
-
د. علوي القشّيبي – تكنولوجيا المعلومات، ذكاء اصطناعي وتعلم الآلة، من اليمن، محاضر في جامعة ماليزية.
-
باحثون في الهندسة الكهربائية، وهندسة القدرة والإلكترونيات، وعلوم الكمبيوتر، من اليمن ودول أخرى.
-
متخصصون في فقه وأصوله، وتعليم اللغة العربية، والتربية، من العراق وغيرها.
-
د. سامر – تخصص الحديث والقراءات.
-
د. أكرم – أنظمة معلومات في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، من العراق، مقيم في ماليزيا منذ 25 عامًا.
-
مشاركون من السودان وسوريا وغيرها، يعملون في مجالات الإدارة، التعليم، وتنمية الموارد البشرية.
هذه اللقاءات تُبنى عليها صلات وعلاقات علمية، ويتمنّى الجميع استمرارها، وأن تُبنى عليها مشروعات تعاون قادمة.
خاتمة اللقاء
اختُتم اللقاء بالشكر للدكتور متوكل على الاستضافة في «Asia Pacific» بماليزيا – بوتراجايا، وبالشكر لجميع الحاضرين على مشاركتهم ومداخلاتهم، ودعاء بأن يتقبّل الله هذا الجهد وينفع به.