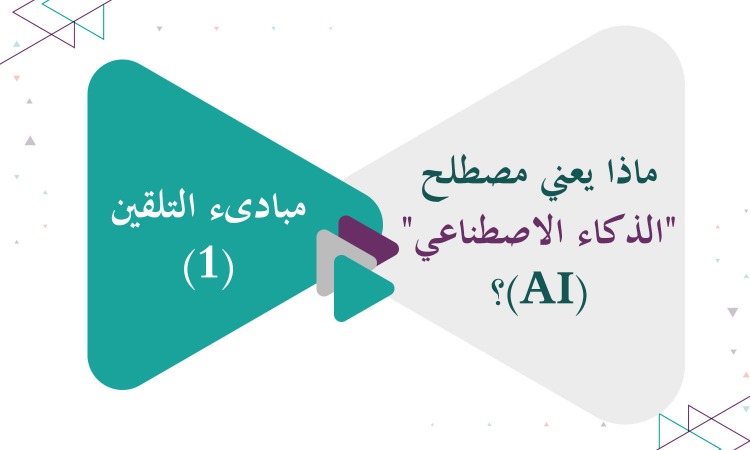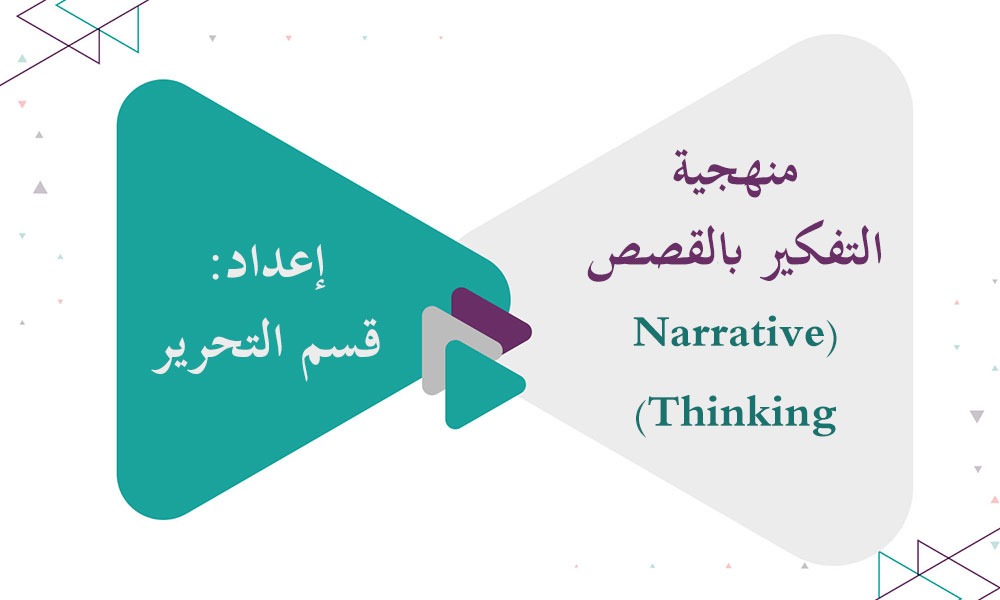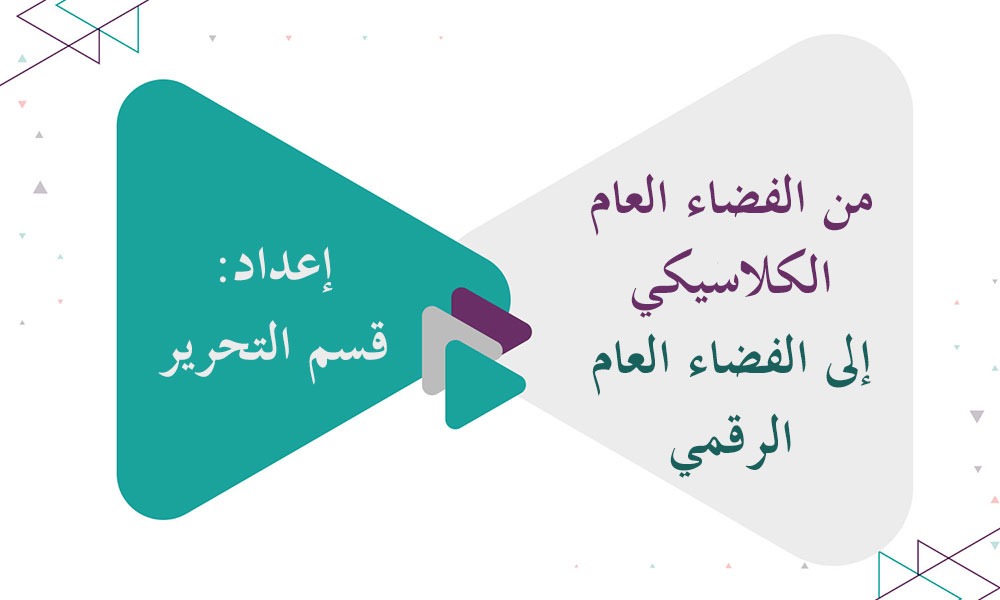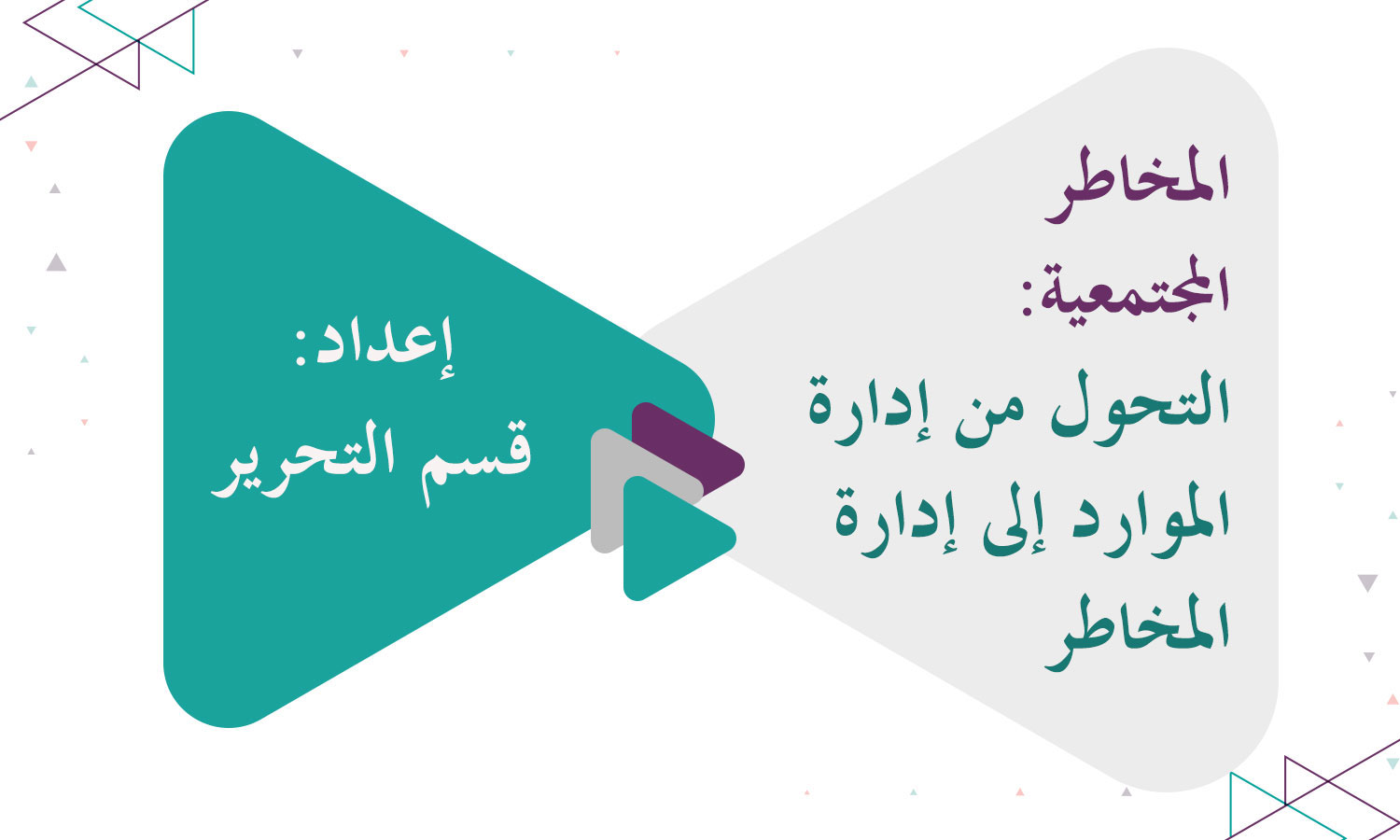تُعدّ نظرية المخاطر المجتمعية (Risk Society Theory) من أبرز الإسهامات الفكرية في علم الاجتماع الحديث، وقد صاغ ملامحها عالم الاجتماع الألماني أولريش بيك (Ulrich Beck) في كتابه الشهير “مجتمع المخاطر” الصادر عام 1986. جاءت هذه النظرية في مرحلة شهد فيها العالم تحولات تكنولوجية عميقة، من الثورة الصناعية المتأخرة إلى الثورة الرقمية، مما جعل الخطر جزءًا من الحياة اليومية، لا حادثًا استثنائيًا.
أولًا: جوهر النظرية
ترى النظرية أن المجتمعات الحديثة لم تعُد تُدار على أساس توزيع الثروة أو الموارد فحسب، بل أصبحت معنية أكثر بـ توزيع المخاطر الناتجة عن التقدّم العلمي والتكنولوجي. فكل ابتكار يحمل في طياته احتمالات غير متوقعة، من الأضرار البيئية إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.
يُشير بيك إلى أن الحداثة - التي كانت تُبشّر بالرفاه والسيطرة على الطبيعة - أفرزت نوعًا جديدًا من القلق الجمعي، حيث أصبحت التقنية مصدرًا للمخاطرة بقدر ما هي أداة للراحة.
أولًا: جوهر النظرية
ترى النظرية أن المجتمعات الحديثة لم تعُد تُدار على أساس توزيع الثروة أو الموارد فحسب، بل أصبحت معنية أكثر بـ توزيع المخاطر الناتجة عن التقدّم العلمي والتكنولوجي. فكل ابتكار يحمل في طياته احتمالات غير متوقعة، من الأضرار البيئية إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.
يُشير بيك إلى أن الحداثة - التي كانت تُبشّر بالرفاه والسيطرة على الطبيعة - أفرزت نوعًا جديدًا من القلق الجمعي، حيث أصبحت التقنية مصدرًا للمخاطرة بقدر ما هي أداة للراحة.
ثانيًا: من الحداثة الصناعية إلى الحداثة التأملية
يُميّز بيك بين الحداثة الصناعية التي تركّز على الإنتاج والسيطرة، والحداثة التأملية التي تتأمل نتائجها الجانبية. في المرحلة الأولى، كانت المخاطر ملموسة ومحدودة (كالحوادث، والفقر، والمرض)، بينما في المرحلة الثانية أصبحت المخاطر عالمية ومجردة، مثل تغيّر المناخ أو انهيار الأنظمة الرقمية.
فعلى سبيل المثال، كارثة تشيرنوبل النووية عام 1986 مثّلت لحظة مفصلية أثبتت أن التكنولوجيا لا يمكن احتواؤها داخل حدود وطنية. الإشعاعات عبرت القارات، فصار الخطر عابرًا للحدود، وأصبح العالم بأسره يواجه مصيرًا مشتركًا.
يُميّز بيك بين الحداثة الصناعية التي تركّز على الإنتاج والسيطرة، والحداثة التأملية التي تتأمل نتائجها الجانبية. في المرحلة الأولى، كانت المخاطر ملموسة ومحدودة (كالحوادث، والفقر، والمرض)، بينما في المرحلة الثانية أصبحت المخاطر عالمية ومجردة، مثل تغيّر المناخ أو انهيار الأنظمة الرقمية.
فعلى سبيل المثال، كارثة تشيرنوبل النووية عام 1986 مثّلت لحظة مفصلية أثبتت أن التكنولوجيا لا يمكن احتواؤها داخل حدود وطنية. الإشعاعات عبرت القارات، فصار الخطر عابرًا للحدود، وأصبح العالم بأسره يواجه مصيرًا مشتركًا.
ثالثًا: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمجال جديد للمخاطر
مع دخول الألفية الثالثة، انتقل مركز المخاطر من المصانع والمفاعلات إلى الخوارزميات والأنظمة الذكية. فحادثة تسريب بيانات “كامبريدج أناليتيكا” عام 2018 كشفت كيف يمكن أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي في توجيه السلوك السياسي والتأثير على الانتخابات الأمريكية، مما أبرز خطر فقدان السيطرة على البيانات.
وفي عام 2023، حذّر عدد من روّاد الذكاء الاصطناعي، منهم إيلون ماسك وسام ألتمان، من احتمال أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر وجودي على البشرية، مشبّهين الموقف بـ“لحظة أوبنهايمر الرقمية” في إشارة إلى القنبلة النووية.
مع دخول الألفية الثالثة، انتقل مركز المخاطر من المصانع والمفاعلات إلى الخوارزميات والأنظمة الذكية. فحادثة تسريب بيانات “كامبريدج أناليتيكا” عام 2018 كشفت كيف يمكن أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي في توجيه السلوك السياسي والتأثير على الانتخابات الأمريكية، مما أبرز خطر فقدان السيطرة على البيانات.
وفي عام 2023، حذّر عدد من روّاد الذكاء الاصطناعي، منهم إيلون ماسك وسام ألتمان، من احتمال أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر وجودي على البشرية، مشبّهين الموقف بـ“لحظة أوبنهايمر الرقمية” في إشارة إلى القنبلة النووية.
تلك الأحداث تجسّد مفهوم بيك حول "المخاطر المصنوعة ذاتيًا"، أي تلك التي تولّدها المجتمعات نتيجة تقدّمها العلمي، ولا يمكن التنبؤ بنتائجها أو السيطرة الكاملة عليها.
رابعًا: إدارة المخاطر بدلًا من إدارة الموارد
في المجتمعات التقليدية، كانت التنمية تدور حول إدارة الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الازدهار. أما في المجتمعات الحديثة، فأصبحت الأولوية لإدارة المخاطر الناتجة عن هذا الازدهار ذاته.
فمثلاً، بعد جائحة كوفيد-19 (2020)، تحوّل تركيز الدول من تعزيز الإنتاج إلى بناء أنظمة إنذار مبكر، وتطوير استراتيجيات للمرونة الاجتماعية والصحية. أدركت الحكومات أن القوة لا تكمن في وفرة الموارد، بل في القدرة على التنبؤ بالأزمات والتكيّف معها.
في المجتمعات التقليدية، كانت التنمية تدور حول إدارة الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الازدهار. أما في المجتمعات الحديثة، فأصبحت الأولوية لإدارة المخاطر الناتجة عن هذا الازدهار ذاته.
فمثلاً، بعد جائحة كوفيد-19 (2020)، تحوّل تركيز الدول من تعزيز الإنتاج إلى بناء أنظمة إنذار مبكر، وتطوير استراتيجيات للمرونة الاجتماعية والصحية. أدركت الحكومات أن القوة لا تكمن في وفرة الموارد، بل في القدرة على التنبؤ بالأزمات والتكيّف معها.
خامسًا: انعكاسات نظرية المخاطر على البنية الاجتماعية
- تحوّل الثقة: لم تعُد الثقة تُمنح تلقائيًا للمؤسسات العلمية والسياسية، بل أصبحت مشروطة بالشفافية والمساءلة.
- تحوّل الثقة: لم تعُد الثقة تُمنح تلقائيًا للمؤسسات العلمية والسياسية، بل أصبحت مشروطة بالشفافية والمساءلة.
- ظهور مجتمع المراقبة: ازدياد الرقابة الرقمية بهدف “الأمن” أوجد تساؤلات أخلاقية حول الخصوصية.
- تراجع اليقين العلمي: أصبح العلم ذاته مصدرًا للقلق، لأنه لا يقدم يقينًا مطلقًا بل احتمالات.
- تولّد حركات اجتماعية جديدة: مثل حركة “الجمعة من أجل المستقبل” بقيادة غريتا تونبرغ (2018) التي طالبت بمواجهة المخاطر البيئية الناتجة عن التقدّم الصناعي.
سادسًا: العلاقة بالنهوض الحضاري
تكتسب نظرية المخاطر المجتمعية أهمية خاصة في سياق النهوض الحضاري للأمم الإسلامية والعربية، إذ تقدم وعيًا استباقيًا بإدارة الأخطار بدل انتظارها.
النهوض الحضاري، كما يؤكد المفكر جاسم سلطان في “قوانين النهضة” (2011)، لا يقوم فقط على استثمار الفرص، بل على إدراك السنن والتحولات، وتجنب التهلكة الناتجة عن الغفلة.
فإدارة المخاطر تمثل ركيزة في بناء حضارة رشيدة قادرة على حماية الإنسان من آثار التقنية المنفلتة، وصون القيم الأخلاقية في ظل التحول الرقمي.
تكتسب نظرية المخاطر المجتمعية أهمية خاصة في سياق النهوض الحضاري للأمم الإسلامية والعربية، إذ تقدم وعيًا استباقيًا بإدارة الأخطار بدل انتظارها.
النهوض الحضاري، كما يؤكد المفكر جاسم سلطان في “قوانين النهضة” (2011)، لا يقوم فقط على استثمار الفرص، بل على إدراك السنن والتحولات، وتجنب التهلكة الناتجة عن الغفلة.
فإدارة المخاطر تمثل ركيزة في بناء حضارة رشيدة قادرة على حماية الإنسان من آثار التقنية المنفلتة، وصون القيم الأخلاقية في ظل التحول الرقمي.
من هذا المنظور، تتقاطع النظرية مع مفهوم “الوعي السنني” الذي يجعل من قراءة النتائج المترتبة على الأفعال قاعدة لبناء المستقبل. فالنهوض الحضاري لا يُختبر في القدرة على الابتكار فحسب، بل في القدرة على توجيه الابتكار نحو الخير العام، وضبط مخاطره.
سابعًا: تطبيقات عملية للنظرية في مسار النهضة
إدارة الذكاء الاصطناعي بوعي أخلاقي: تأسيس هيئات وطنية لمراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والإعلام، لضمان توافقه مع القيم الإنسانية.
إدارة الذكاء الاصطناعي بوعي أخلاقي: تأسيس هيئات وطنية لمراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والإعلام، لضمان توافقه مع القيم الإنسانية.
بناء ثقافة السلامة الرقمية: إعداد مناهج تربوية تُعلّم الجيل الجديد كيفية حماية بياناته وهويته الرقمية.
سياسات استباقية للأمن الغذائي والبيئي: تطوير نظم مراقبة للزراعة والمياه، تحسبًا لأزمات المناخ التي تشكّل خطرًا على الاستقرار الاجتماعي.
تعزيز مفهوم المرونة المجتمعية (Resilience): تشجيع المبادرات المحلية التي تبني قدرة المجتمعات على التكيّف مع الأزمات، كما فعلت بعض المدن بعد الزلازل أو الجوائح.
ثامنًا: من الخوف إلى الوعي
تقدّم نظرية المخاطر المجتمعية منظورًا تحويليًا: فهي لا تدعو إلى الخوف من التقدم، بل إلى الوعي بما ينتجه.
فكل مشروع نهضوي يحتاج إلى “إدارة حكيمة للمخاطر” كي لا يتحوّل الإنجاز إلى تهديد.
وعندما يصبح الوعي بالمخاطر جزءًا من ثقافة التخطيط الحضاري، يتحول الخطر إلى فرصة لتجديد البنى الاجتماعية، وتعزيز العدالة، وتوطيد علاقة الإنسان بالطبيعة والتقنية في آنٍ واحد.
تقدّم نظرية المخاطر المجتمعية منظورًا تحويليًا: فهي لا تدعو إلى الخوف من التقدم، بل إلى الوعي بما ينتجه.
فكل مشروع نهضوي يحتاج إلى “إدارة حكيمة للمخاطر” كي لا يتحوّل الإنجاز إلى تهديد.
وعندما يصبح الوعي بالمخاطر جزءًا من ثقافة التخطيط الحضاري، يتحول الخطر إلى فرصة لتجديد البنى الاجتماعية، وتعزيز العدالة، وتوطيد علاقة الإنسان بالطبيعة والتقنية في آنٍ واحد.
منصة نهضة
تُعيد نظرية المخاطر المجتمعية تعريف العلاقة بين الإنسان والتقنية والتاريخ، إذ تجعل من إدراك الخطر شرطًا للنضج الحضاري.
ومتى امتلكت الأمة وعيًا متوازنًا بالمخاطر، وأقامت مؤسسات للإنذار المبكر والتفكير المستقبلي، تحوّل الخطر إلى منصة نهضة، لا إلى مصدر شلل.
هكذا تُسهم هذه النظرية في توجيه مسار النهوض الحضاري من الانبهار بالتقدم إلى الوعي بنتائجه، ومن التحكم في الموارد إلى التحكم في المصائر.
تُعيد نظرية المخاطر المجتمعية تعريف العلاقة بين الإنسان والتقنية والتاريخ، إذ تجعل من إدراك الخطر شرطًا للنضج الحضاري.
ومتى امتلكت الأمة وعيًا متوازنًا بالمخاطر، وأقامت مؤسسات للإنذار المبكر والتفكير المستقبلي، تحوّل الخطر إلى منصة نهضة، لا إلى مصدر شلل.
هكذا تُسهم هذه النظرية في توجيه مسار النهوض الحضاري من الانبهار بالتقدم إلى الوعي بنتائجه، ومن التحكم في الموارد إلى التحكم في المصائر.