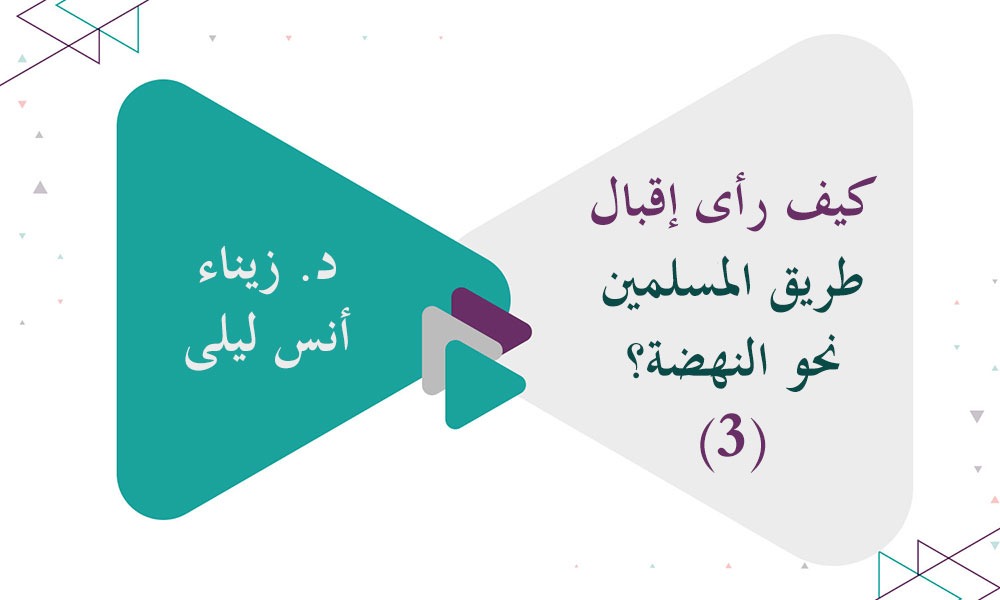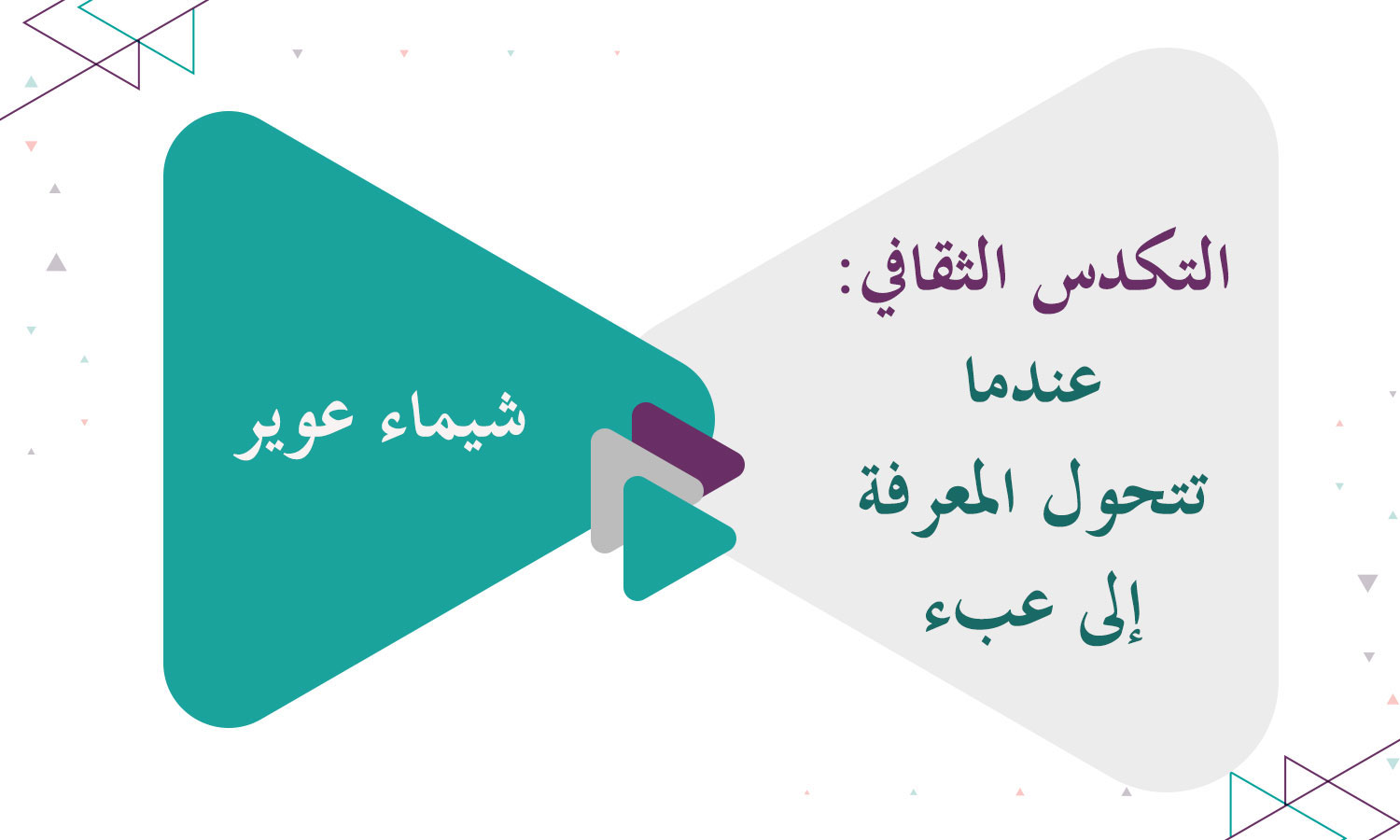يقول مالك بن نبي: "المجتمع الذي يقرأ ليكدّس المعرفة لا ليغيّر سلوكه هو مجتمع يقرأ ليبقى متخلّفًا."
هذه الجملة وحدها تكشف لنا مشكلة عميقة نعيشها اليوم، وهي أن كثيرًا من الناس يظنّون أن المعرفة وحدها تكفي لتغيير الواقع، بينما الحقيقة أن التغيير لا يحدث إلا عندما تتحول المعرفة إلى عمل وسلوك ومعنى يُعاش.
هذه الجملة وحدها تكشف لنا مشكلة عميقة نعيشها اليوم، وهي أن كثيرًا من الناس يظنّون أن المعرفة وحدها تكفي لتغيير الواقع، بينما الحقيقة أن التغيير لا يحدث إلا عندما تتحول المعرفة إلى عمل وسلوك ومعنى يُعاش.
مالك بن نبي كان يقصد بـ"التكدس الثقافي" تلك الحالة التي يصبح فيها الإنسان مثل خزانٍ مملوءٍ بالأفكار والمفاهيم، لكنه لا يستفيد منها في حياته اليومية. يقرأ، يسمع ويحفظ، يناقش... لكنه لا يطبّق. وهكذا تبقى أفكاره حبيسة رأسه، لا تخرج إلى أرض الواقع، ولا تغيّر شيئًا في سلوكه أو في طريقة نظره إلى الحياة.
لنأخذ مثالًا بسيطًا: شخص قرأ عشرات الكتب في التربية والأخلاق والفلسفة، وحفظ أقوال المفكرين، ولكنه في واقعه ما زال يصرخ في وجه أطفاله، ويعامل الناس بقسوة، ويحتقر من يختلف معه.
أليس هذا تناقضًا؟ كيف لإنسان يعرف الكثير عن التربية والحكمة، لكنه لا يربّي نفسه أولًا؟
أليس هذا تناقضًا؟ كيف لإنسان يعرف الكثير عن التربية والحكمة، لكنه لا يربّي نفسه أولًا؟
هنا نفهم أن المعرفة لوحدها لا تصنع الإنسان الواعي، بل القدرة على ترجمتها إلى فعلٍ وسلوكٍ هي التي تصنع الفرق.
ونفس الشيء نلاحظه في مجالات أخرى:
مثلًا كثير من الناس يقرأون كتبًا في المال والتنمية البشرية مثل الأب الغني والأب الفقير أو كيف تصبح غنيًا أو ناجحًا، ويتحدثون عن المشاريع والاستثمار، لكنهم لا يقومون بأي خطوة حقيقية؛ لا يفتحون مشروعًا، ولا يجرّبون فكرة، ولا حتى يحاولون التغيير. فتبقى أفكارهم مجرد أحلام على الورق أو أحاديث في المقاهي، لا أكثر.
مثلًا كثير من الناس يقرأون كتبًا في المال والتنمية البشرية مثل الأب الغني والأب الفقير أو كيف تصبح غنيًا أو ناجحًا، ويتحدثون عن المشاريع والاستثمار، لكنهم لا يقومون بأي خطوة حقيقية؛ لا يفتحون مشروعًا، ولا يجرّبون فكرة، ولا حتى يحاولون التغيير. فتبقى أفكارهم مجرد أحلام على الورق أو أحاديث في المقاهي، لا أكثر.
وهنا يعود كلام مالك بن نبي بقوة حين قال:
"الفكرة التي لا تنزل من رأسك إلى يدك هي مجرد عبء فكري، لا أداة تغيير."
"الفكرة التي لا تنزل من رأسك إلى يدك هي مجرد عبء فكري، لا أداة تغيير."
وبالفعل، فالفكرة إن بقيت في الرأس فقط تصبح عبئًا على صاحبها، تجعله يعيش بين الوهم والفعل، بين ما يتمنى أن يكونه وما هو عليه فعلًا. لذلك فالمشكل ليس في نقص الثقافة أو قلة القراءة، بل في ضعف الإرادة والتطبيق، لأن الإنسان لا يُقاس بعدد الكتب التي قرأها، بل بمدى قدرته على أن يجعل مما قرأه واقعًا يعيشه، أي يطبّقه في حياته.
فمالك بن نبي كان يريد أن يوقظ فينا هذا الوعي:
أن القراءة لا معنى لها إن لم تغيّر فينا شيئًا، وأن المثقف الحقيقي ليس من يعرف الكثير، بل من يغيّر سلوكه حين يعرف. فالفكر الذي لا يثمر عملًا ليس له أي فائدة، بل قد يصبح وسيلة نبرّر بها عجزنا، فنقول: أنا مثقف، أنا أعرف، دون أن يكون لعلمنا أثر على حياتنا أو على مجتمعنا.
أن القراءة لا معنى لها إن لم تغيّر فينا شيئًا، وأن المثقف الحقيقي ليس من يعرف الكثير، بل من يغيّر سلوكه حين يعرف. فالفكر الذي لا يثمر عملًا ليس له أي فائدة، بل قد يصبح وسيلة نبرّر بها عجزنا، فنقول: أنا مثقف، أنا أعرف، دون أن يكون لعلمنا أثر على حياتنا أو على مجتمعنا.
إن التكدس الثقافي هو عكس الوعي الحقيقي، لأن الوعي لا يُقاس بالكمّ بل بالكيف.
فقد يقرأ إنسان كتابًا واحدًا ويُحدث به ثورة في فكره وسلوكه، بينما يقرأ آخر مئة كتاب ويبقى كما هو، لا يتغيّر في شيء. ولهذا علينا أن نعيد النظر في علاقتنا بالمعرفة:
- هل نقرأ لنتباهى أم لنتغيّر؟
- هل نطلب العلم لنبدو أذكياء أم لنصير أنقى وأفضل؟
فقد يقرأ إنسان كتابًا واحدًا ويُحدث به ثورة في فكره وسلوكه، بينما يقرأ آخر مئة كتاب ويبقى كما هو، لا يتغيّر في شيء. ولهذا علينا أن نعيد النظر في علاقتنا بالمعرفة:
- هل نقرأ لنتباهى أم لنتغيّر؟
- هل نطلب العلم لنبدو أذكياء أم لنصير أنقى وأفضل؟
فالقراءة الحقيقية هي التي تترك أثرًا في الروح قبل أن تملأ العقل، وتجعلنا نحس بالمسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه العالم.
لكن اليوم، ونحن نعيش في زمنٍ غزيرٍ بالمعلومات، زمن الذكاء الاصطناعي، صار التكدس الثقافي يأخذ شكلًا جديدًا. هنا لم يعد الإنسان يكدّس الكتب في مكتبته فقط، بل صار يكدّس الإجابات الجاهزة في ذاكرته دون أن يفكر فيها.
فمثلًا في عصر ما يُسمّى بـ (شات جي بي تي) والمحتوى السريع، صار البعض يظن أن امتلاك الإجابة هو الفهم، وأن السرعة تعني الوعي، بينما الحقيقة أن الفكر لا يولد من تكرار الكلام، بل من محاورة الفكرة وفهمها وتمثّلها. حتى أصبحت الناس تشك في صدق كل ما يُكتب، فيقول أحدهم: "هذا أكيد كاتبه الذكاء الاصطناعي!"، وكأننا فقدنا الثقة في قدرتنا على التفكير بأنفسنا، وصارت الكلمات تُقاس بآلة لا بروح صاحبها.
وهنا يظهر الخطر الحقيقي: أن نتحول إلى مجرد مستهلكين للمعرفة، لا خالقين لها؛ إلى عقول تحفظ ولا تفكر، تنسخ ولا تُبدع.
فالذكاء الاصطناعي ليس عدوًّا، لكنه مرآة لذكائنا نحن، فإن استخدمناه بوعي صار وسيلة للفهم والابتكار، وإن استسلمنا له صار شكلًا جديدًا من أشكال التكدس الثقافي الذي حذّر منه مالك بن نبي قبل عقود.
ولعل رسالته اليوم تُعاد إلينا بلغة أخرى:
لا تكدّس المعرفة، بل اجعلها تنبض فيك فكرًا وعملًا، ولا تكتفِ بالإجابات الجاهزة، بل ابحث عن سؤالك الخاص، لأن الوعي يبدأ من السؤال لا من الحفظ.
لا تكدّس المعرفة، بل اجعلها تنبض فيك فكرًا وعملًا، ولا تكتفِ بالإجابات الجاهزة، بل ابحث عن سؤالك الخاص، لأن الوعي يبدأ من السؤال لا من الحفظ.
وفي النهاية، لا يكفي أن تكون مثقفًا بالكلام، بل أن تكون مثقفًا بالفعل.
فما قيمة النور إن لم يُبدّد الظلام؟
وما نفع الفكرة إن لم تصنع إنسانًا جديدًا؟
فما قيمة النور إن لم يُبدّد الظلام؟
وما نفع الفكرة إن لم تصنع إنسانًا جديدًا؟