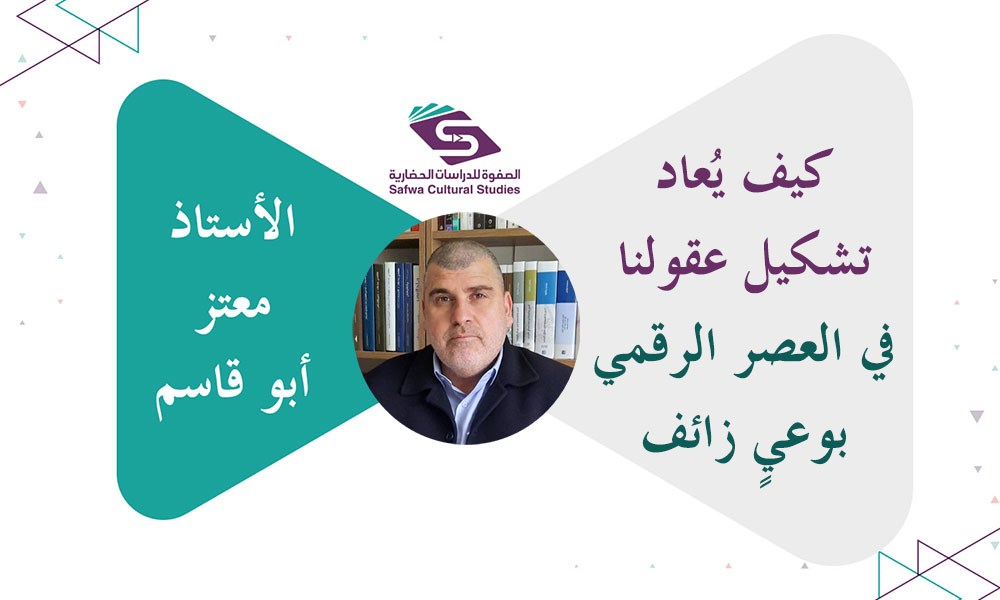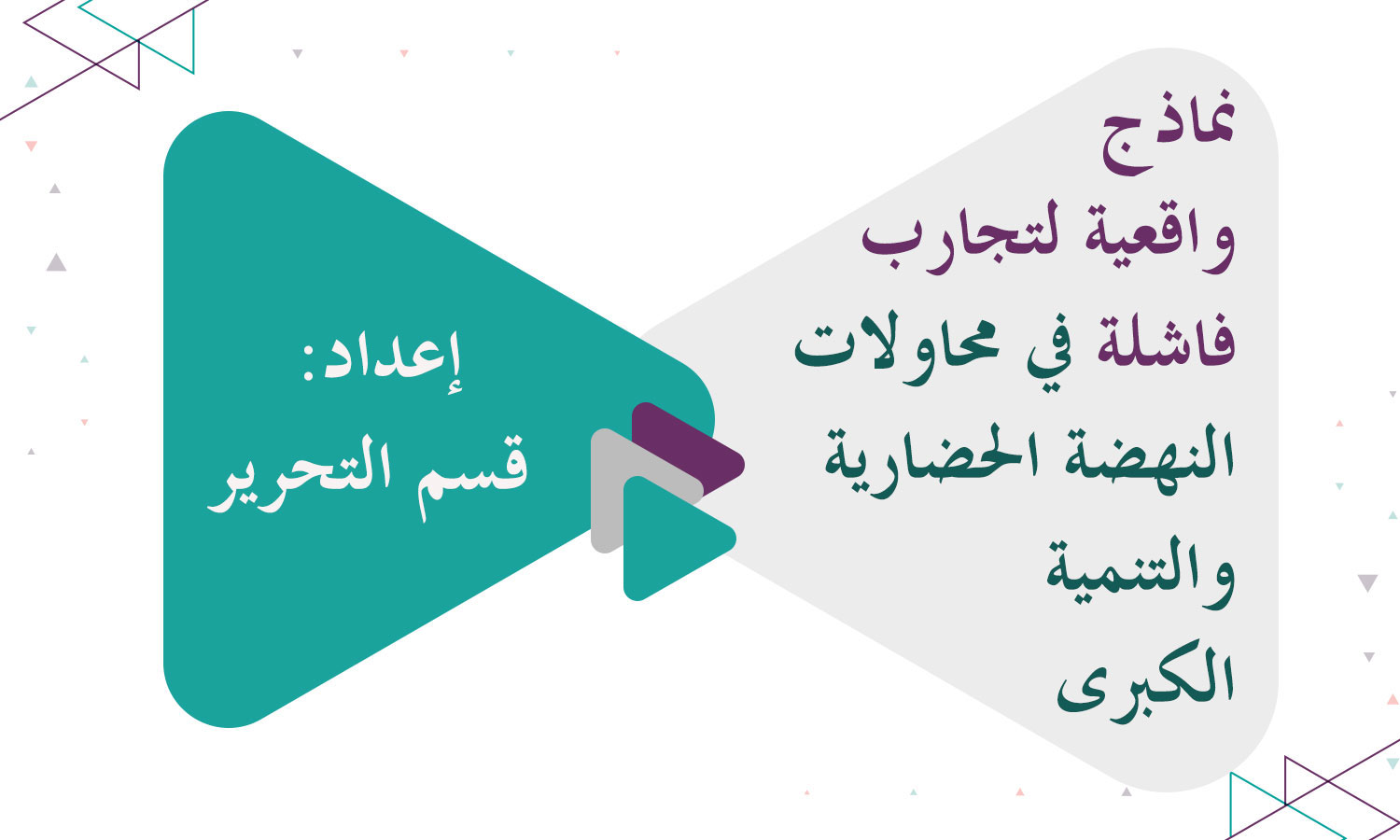عندما تنطلق دولة أو مجتمع بفكرة النهوض الحضاري، فإنها تراهن على تغييرات شاملة في البُنى الفكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية. لكن الواقع يكشف أن العديد من التجارب تحوّلت إلى مشاريع “نهضة مكسورة” لا تتحقّق أهدافها أو تنتهي بفشل جزئي أو كلي. دراسة هذه التجارب لا تهدف إلى التشاؤم، بل إلى استخلاص الدروس التي تمكِّن الأجيال الجديدة من تجنب الأخطاء الكبرى. في هذه الورقة نعرض أربعة أمثلة معاصرة أو تاريخية بارزة، ثم نحلل الأسباب التي أدّت إلى إخفاقها.
نماذج لتجارب فاشلة
1. مشروع الفول السوداني في تنغانيقا (East Africa Groundnut Scheme)
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أطلقت الحكومة البريطانية مشروعًا في مستعمرتها آنذاك، تنغانيقا (حاليًّا جزء من تنزانيا)، لزراعة مساحات واسعة من الفول السوداني (groundnut) بغية إنتاج الزيوت واستيرادها إلى بريطانيا.
ما حصل فعليًا:
- تم اختيار الأراضي في مناطق غير مناسبة من الناحية المناخية والتربة، دون دراسات كافية.
- البنية التحتية للنقل (سكك الحديد، الطرق) كانت ضعيفة، مما زاد تكلفة نقل المعدات والمحاصيل.
- المعدات الزراعية المستوردة لم تكن ملائمة أو لم تُستخدم بطريقة صحيحة (بعضها كان صدئًا أو غير صالح للعمل).
- المشروع تكبّد خسائر ضخمة، إذ أن الكميات المحصودة لم تُغطِّ منطقتين صغيرتين من الأرض المزمع زراعتها، وفي النهاية تقرر التوقف عنه.
هذا المشروع يُعتبر مثالًا كلاسيكيًّا على الإخفاق التخطيطي والتنفيذي متمثّل في تفاوت بين الطموح والواقع الميداني.
2. خطة قسنطينة في الجزائر (Constantine Plan)
في ذروة الاستعمار الفرنسي، أُعلن في عام 1958 “خطة قسنطينة” كبرنامج تنموي شامل يهدف إلى تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الجزائريين والفرنسيين، عبر استثمارات في التعليم والإسكان والبنية التحتية والزراعة.
معوقات التنفيذ:
- الهدف السياسي كان مهمًّا: تهدئة الحركة الوطنية واحتواءها أكثر من كونه نهضة ذاتية.
- التزام مالي عالي من الحكومة الفرنسية لم يكن مستدامًا، خاصة في سياق الحرب واحتياجات عسكرية متزايدة.
- تنفيذ المشاريع تم بطريقة مركزية من النُخب الفرنسية، مع تجاهل السياق المحلي في الريف والمناطق النائية.
- جزء كبير من التوزيع الزراعي للأراضي لم يُنجز كما وعدوا، كما أن التعليم ارتبط بمصادر أجنبية ولم يُرسَّخ استدامة محلية.
باختصار، الخطة فشلت في تحقيق الأهداف الكبرى، وظلت تُنظر إليها كجزء من استراتيجيات الاستعمار أكثر من مشروع نهضة حقيقية.
3. «Operation Feed Yourself» في غانا
في السبعينيات، أطلقت غانا برنامجًا زراعيًا طموحًا يُعرف بـ Operation Feed Yourself، يهدف إلى تحقيق اكتفاء غذائي ورفع الإنتاج المحلي للاستهلاك الداخلي بدل التركيز على التصدير.
أسباب الفشل:
- البنية التحتية الريفية (طرق، معدات تخزين، نقل) كانت غير كافية، فالكثير من الإنتاج تلف أو بقي غير مسوّق.
- الآليات الحكومية في توزيع القروض أو المدخلات الزراعية فضّلت المزارع الكبيرة على الصغرى، مما أضعف مشاركة الفلاحين المحليين.
- الرقابة والشفافية كانت ضعيفة، مما أدّى إلى سوء استغلال الموارد أو تحويلها لأغراض شخصية.
- التحفيز على الزراعة المحلية خُفض تدريجيًّا لصالح الإنتاج للتصدير، فابتعد كثير من المزارعين عن المشروع للقِطاع الربحي.
- في نهاية المطاف ظل العجز الغذائي مرتفعًا، وانخفضت ثقة الناس في قدرة الدولة على تأمين احتياجاتهم الغذائية.
4. الإصلاحات في الجمهورية العربية اليمنية - “المبادرة التصحيحية”
في الفترة من 1974 إلى 1977، قاد الرئيس اليمني إبراهيم الحمدي إصلاحات جذرية تحت عنوان المبادرة التصحيحية، شملت التعليم، الصحّة، الإدارة، القضاء على الحزبيات القبلية، تحديث الجيش، ومحاولة توجيه الدولة نحو النمو.
محددات التعثر:
- الإصلاحات اقتربت من استهداف قوى تقليدية قوية مثل الزعماء القبليين وأصحاب النفوذ، مما أثار مقاومتهم.
- عملية تنفيذ الإصلاحات كانت سريعة وربما متعجلة، مما قلل من قدرة المؤسسات على التكيف والتعديل التدريجي.
- وفاة الحمدي قبل أن يُكمل مشروعه، ومن بعده جاءت قيادات ذات نُفَس محافظ، مما أوقف الزخم.
- السياق الإقليمي والتدخلات الخارجية أثرت على استقرار السياسة والإصلاح، فالمبادرة فُقدت في خضم المنافسات.
- في النهاية بعض المشاريع في البنية التحتية والتعليم تحققّت، لكن الإصلاح الشامل والعميق بقي ناقصًا أو مؤجَّلًا.
5. فشل الخطط الخمسية في سوريا
منذ منتصف القرن العشرين، اعتمد النظام السوري عددًا من الخطط الخمسية للتنمية (على نمط الاشتراكية التخطيطية)، ومع ذلك كثير منها لم يُحقق الأهداف المعلنة.
عوامل الفشل الملحوظ:
- الطموحات كانت كبيرة جدًا على الورق مقارنة بالقدرات الاقتصادية على الأرض.
- الانخراط في السياسة الإقليمية وموازنات الأمن دفع كثيرًا من الموارد بعيدًا عن المشاريع التنموية.
- اعتماد كبير على الدعم الخارجي والاستثمارات الأجنبية، مما جعل بعض المشاريع عرضة للتقلّبات الدولية.
- ضعف الكفاءة الإدارية، البيروقراطية، وسوء التخطيط في توزيع المشاريع بين المدن والمناطق الريفية.
- الحروب والأزمات المتلاحقة دفعت معظم الموارد إلى متطلبات أمنية وعسكرية، فتوقفت بعض المشاريع التنموية.
تحليل الأسباب المشتركة لتعثر النهوض
من خلال هذه النماذج المتنوعة، تظهر عدة عوامل مشتركة يمكن اعتبارها عوامل معيقة أو مدمّرة لمشاريع النهضة:
أ. الفجوة بين الطموح والواقعيّة
غالبًا ما تُصاغ الخطط برؤية متفائلة عديمة الحسابات الواقعية. يُعدّ هذا الخطأ من أبرز المصادر التي تؤدي إلى ضعف التنفيذ أو الفشل.
ب. ضعف الدراسات الميدانية والتخطيط السياقي
التصميم دون دراسات حول المناخ، البيئة، البنية التحتية المحلية، والثقافة يؤدي إلى حلول غير ملائمة، كما تظهر في تجربة الفول السوداني وتنغانيقا.
ج. البنية التحتية الهشة
دون شبكة طرق مناسبة، مرافق نقل، تخزين، طاقة، أو مرافق دعم، تفشل المشاريع الزراعية والصناعية في الوصول إلى الأسواق أو المحافظة على جودتها.
د. سوء الإدارة والفساد
انعدام الشفافية وتحويل الموارد أو القروض إلى أغراض غير مشروع هي أمر شائع في المشاريع الضخمة. كثير من المشاريع توزّع قروضًا وما تُنفَّذ منها إلا القليل.
هـ. المعارضة السياسية والاجتماعية
التغيير الجذري غالبًا ما يهدّد مصالح النُخب التقليدية (قبائل، زعماء محليّون، جهات اقتصادية) فتقاومه بالقوة أو الإعاقة، كما في حالة المبادرة التصحيحية في اليمن.
و. غياب الاستمرارية السياسية
وفاة قائد، انقلاب، تغيّر في القيادة أو تغيير في الأيديولوجيا يمكن أن يجهض المشروع كما حدث في الجزائر واليمن وسوريا.
ز. الاعتماد الخارجي وتقلبات السياق الدولي
التمويل الأجنبي أو الدعم الدولي قد يزهد الدولة في تصميم مشاريع قائمة على دعم خارجي، فتتأثر المشاريع بمعطيات خارجية كالأسعار العالمية أو السياسات الدولية.
ح. اللامركزية أو التوزيع غير العادل
تركيز المشاريع في المدن والمناطق الحضرية على حساب الريف، أو تجاهل الفئات المهمشة، يضيّع فرص إشراك معظم السكان، مما ينتج رفضًا شعبيًّا أو ضعفًا في الفاعلية.
ط. غياب المرونة والتكيف
المشاريع المُجهّزة بعقود جامدة وغير قابلة للتعديل عند ظهور عوائق، تنهار أمام المتغيرات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
الدروس المستخلصة وأسس النجاح اللاحق
من دراسة هذه التجارب يمكن اقتراح مؤشرات لنجاح مشاريع النهضة المستقبليّة:
1. الحمولة الواقعية
يجب أن تُبنى الخطط على تحليل دقيق وإحصاءات محلية، مع توليد سيناريوهات بديلة.
يجب أن تُبنى الخطط على تحليل دقيق وإحصاءات محلية، مع توليد سيناريوهات بديلة.
2. المشاركة الاجتماعية والتشاركية
إشراك المجتمعات المحلية، الفلاحين، الشباب، قيادات المجتمع في تصميم وتنفيذ المشروع لضمان القبول والتواصل.
إشراك المجتمعات المحلية، الفلاحين، الشباب، قيادات المجتمع في تصميم وتنفيذ المشروع لضمان القبول والتواصل.
3. الإدارة الرشيدة والشفافّة
اعتماد أنظمة محاسبية مفتوحة، رقابة مدنية داخلية وخارجية، ومكافحة الفساد بصرامة.
اعتماد أنظمة محاسبية مفتوحة، رقابة مدنية داخلية وخارجية، ومكافحة الفساد بصرامة.
4. البنى التحتية المساندة القوية
قبل إطلاق مشروع زراعي أو صناعي فإن توفير الطرق، الطاقة، النقل، التخزين أمر محوري.
قبل إطلاق مشروع زراعي أو صناعي فإن توفير الطرق، الطاقة، النقل، التخزين أمر محوري.
5. التدرج والمرونة
بدء المشاريع على نطاق محدود كمشاريع تجريبية، ثم التوسع تدريجيًّا. مع وجود آليات لتعديل الخطة وفق المتغيرات.
بدء المشاريع على نطاق محدود كمشاريع تجريبية، ثم التوسع تدريجيًّا. مع وجود آليات لتعديل الخطة وفق المتغيرات.
6. التركيز على التنوع الاقتصادي
ألا تعتمد الدولة على قطاع زراعي أو سياسي واحد، بل تنوع في الإنتاج والمعرفة لتحمّل الصدمات.
ألا تعتمد الدولة على قطاع زراعي أو سياسي واحد، بل تنوع في الإنتاج والمعرفة لتحمّل الصدمات.
7. الاستدامة الاقتصادية
اعتماد نماذج تمويل داخلي، إعادة استثمار الأرباح، وتقليل الاعتماد على القروض والهبات الخارجية.
اعتماد نماذج تمويل داخلي، إعادة استثمار الأرباح، وتقليل الاعتماد على القروض والهبات الخارجية.
8. الرؤية الطويلة الأجل والسياسية المستقرة
ربط المشروع بخارطة طريق تمتد لأجيال، مع ضمان استمرارية التنفيذ حتى في تغيّر القيادة.
ربط المشروع بخارطة طريق تمتد لأجيال، مع ضمان استمرارية التنفيذ حتى في تغيّر القيادة.
9. إدارة التغيّر الثقافي
إدخال التغييرات في القيم والعادات يحتاج وقتًا وتربية ثقافية. فرض التغيير بقوة غالبًا ما يلتفّ عليه المجتمع.
إدخال التغييرات في القيم والعادات يحتاج وقتًا وتربية ثقافية. فرض التغيير بقوة غالبًا ما يلتفّ عليه المجتمع.
10. الرصد والتقييم المستمرّ
وجود مؤشرات أداء ومراقبة دورية تصحّح الانحرافات مبكرًا، وتعيد توجيه المشروع حسب النتائج على الأرض.
وجود مؤشرات أداء ومراقبة دورية تصحّح الانحرافات مبكرًا، وتعيد توجيه المشروع حسب النتائج على الأرض.
النهوض الحقيقي
التجارب الفاشلة لمفاهيم النهضة هي ذخيرة علمية قيّمة لمن أراد أن ينبش في أسباب الفشل ويتعلّم منها. فمشاريع النهوض عمليات معقّدة تدور في مضمار الواقع الميداني، والتفاعلات السياسية، والعوامل الثقافية. إن النهوض الحقيقي يتطلّب حكمة التدرج، وشفافية التنفيذ، ورؤية تشاركية، وقدرة على التكيف مع المتغيرات.